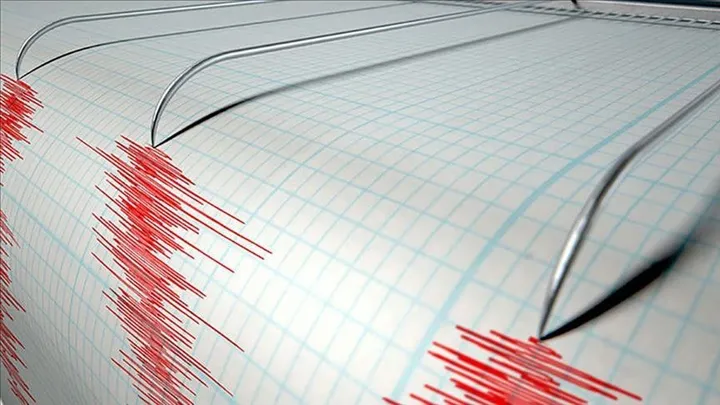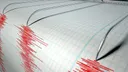عرفت فلسطين السينما وصناعتها منذ منتصف القرن العشرين، إذ شهدت المدن الفلسطينية، لا سيما الساحلية منها مثل يافا وحيفا وعكا، افتتاح عدد من دور العرض، كما استضافت مسارحها ومراكزها الثقافية نخبة من نجوم السينما العربية، خصوصاً المصرية.
ورغم بعض المحاولات المبكرة للإنتاج السينمائي آنذاك، ظل الحضور محدوداً إلى أن وقعت نكبة عام 1948، التي جرفت معها مؤسسات المجتمع الفلسطيني كافة، وحوّلت الشعب إلى جماعات من اللاجئين في الشتات. ومع هذا التحول، اندثرت البذور الأولى لمشروع سينمائي محلي كان في طور التشكل.
لكن النكبة لم تُنهِ الطموح الفلسطيني في التعبير عبر الصورة، إذ برز جيل جديد من المخرجين بعد تشتت النخب الفلسطينية في دول مختلفة، وارتبطت تجربتهم ببدايات الثورة الفلسطينية في ستينيات القرن الماضي، فقد أسس هؤلاء رؤيتهم السينمائية على الذاكرة والهوية، وجعلوا الكاميرا أداة للمقاومة الثقافية.
ومع انطلاق الثورة، ظهرت مؤسسات سينمائية تابعة لفصائل فلسطينية ثم لمنظمة التحرير لاحقاً، وقدمت هذه المؤسسات التمويل والتدريب والدعم اللوجستي، مما ساعد على نشوء تيار سينمائي فلسطيني أكثر وضوحاً، يهدف إلى توثيق المعاناة ورواية القصة الفلسطينية للعالم.
"سينما الثورة"
ويشير سليم البيك، في كتابه "سيرة لسينما الفلسطينيين.. محدودية المساحات والشخصيات" الصادر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية، إلى ما أكده المخرج مصطفى أبو علي في أكثر من موضع: أن الانتماء إلى السينما الفلسطينية ليس مسألة هوية جغرافية أو قومية، بل هو بالأساس التزام فكري ونضالي. فالأفلام الفلسطينية، كما يرى أبو علي، هي تلك التي تعبّر عن الثورة وتجسد روايتها، بغض النظر عن جنسية أو خلفية صانعها.
وقد تميزت أفلام الثورة الفلسطينية، منذ انطلاقتها عام 1969 وحتى الخروج من بيروت عام 1982 وما تبعه من تراجع للثورة، بأنها وليدة جهد جماعي عربي وفلسطيني مشترك، من حيث التمويل والإنتاج، بل إن البعد العربي كان حاضراً في بعض الأحيان بقدر الحضور الفلسطيني أو يفوقه، وهو ما صاغه البيك بمصطلح "سينما الثورة الفلسطينية"، التي اتخذت الكاميرا وسيلة لتوثيق النضال ونقله إلى الرأي العام العالمي.
ومن أبرز أفلام تلك المرحلة فيلم "عائد إلى حيفا"، المقتبس عن رواية غسان كنفاني التي تحمل الاسم نفسه. تولى إخراجه السينمائي العراقي قاسم حول، الذي كتب السيناريو أيضاً، فيما استعان بالكاتب الفلسطيني رشاد أبو شاور لصياغة الحوارات باللهجة الفلسطينية، حرصاً على أصالتها وقربها من المتلقي المحلي.
وشارك في بطولة الفيلم الفنان السوري جمال سليمان، إلى جانب الممثلة الألمانية كريستينا شورن.
ما بعد بيروت
شن الاحتلال الإسرائيلي عام 1982 حرباً مفتوحة على منظمة التحرير الفلسطينية ولبنان، واجتاح الأراضي اللبنانية ووصولاً إلى مدينة بيروت، وانتهت الحرب بخروج منظمة التحرير وخسارتها قاعدة صلبة ووجود تاريخي راكمته فيه لسنوات.
هذا الأمر كان له انعكاسات كبيرة، سواء على مستوى سردية الثورة الفلسطينية أو على مستوى وجود مؤسساتها وفاعليتها. وفي ظل هذه الأوضاع تصاعد دور الداخل الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل.
ويشير سليم البيك إلى أن مرحلة ما بعد الثورة، أي منذ مطلع الثمانينيات، مثّلت نقطة تحوّل في مسار السينما الفلسطينية، سواء في الشكل أو في المضمون. فقد انتقلت بؤرة الإنتاج من ساحات المنفى والمؤسسات المرتبطة بالثورة إلى الداخل الفلسطيني نفسه، لتصبح الكاميرا وسيلة لرواية قصص الحياة اليومية تحت الاحتلال من قلب الأرض.
يضيف سليم البيك أن هذا التحول التاريخي في مسار السينما الفلسطينية تجلّى بوضوح مع أعمال روائية طويلة شكلت منعطفاً فارقاً، فقدّم ميشيل خليفي فيلمه الشهير عرس الجليل عام 1987، تلاه رشيد مشهراوي بفيلم حتى إشعار آخر (1994)، ثم جاء إيليا سليمان بفيلمه سجل اختفاء (1996).
ويؤكد البيك أن هذه الأعمال، رغم أنها فلسطينية في مضمونها وبيئتها، أُنتجت بتمويلات أجنبية من بلجيكا وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وغيرها، ما يبرز غياب البنية الإنتاجية المحلية القادرة على دعم مشاريع سينمائية كبرى.
يُعَدّ فيلم "عرس الجليل" واحداً من أهم الأفلام الفلسطينية في تلك المرحلة، وهو من إخراج ميشيل خليفي، وقد جرى تصويره في قرى فلسطينية داخل أراضي 1948. تدور أحداث الفيلم حول شخصية "أبو عادل" الذي يضطر إلى طلب إذن من الحاكم العسكري الإسرائيلي لرفع حظر التجول المفروض على قريته، حتى يتمكّن من إقامة حفل زفاف ابنه بصورة لائقة. ومن خلال هذه الحبكة، يكشف الفيلم عن تداخل اليومي والسياسي في حياة الفلسطينيين، وكيف تصبح المناسبات الاجتماعية محاطة دوماً بسلطة الاحتلال وأدواته.
وحول قيمته الفنية يشير البيك إلى أن الفيلم "شكّل منطقة عبور من السينما النضالية التسجيلية إلى السينما الروائية المشغولة بهموم الفلسطينيين المباشرة، وترك للاحتلال تمثيل الطارئ والاستثنائي، الذي يتفكك حين يواجه بصلابة الفولكلور الممتدة في التاريخ، وبتراكم المشهد الفلسطيني وحركة الكاميرا المتواصلة المنسجمة مع مفهوم التوق إلى التحرر".
سينما الألفية
مع اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000 وانهيار مسار التسوية السياسية بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، برزت مجموعة من الأفلام التي تناولت ما رافق هذه المرحلة من انتهاكات إسرائيلية من جهة، وتصاعد عمليات المقاومة الفلسطينية من جهة أخرى.
وقد شكلت هذه الحقبة منعطفاً مهماً في تطور السينما الفلسطينية من حيث الموضوعات والمعالجات البصرية.
يشير سليم البيك إلى أن ملامح تلك الفترة تجسدت في ما سماه "الجيمات الخمس: الجندي، والجيب العسكري، والحاجز، والسجن، والجدار"، وهي العناصر التي فرضت حضورها القسري على الحياة اليومية للفلسطينيين، وبالتالي على المشهد السينمائي ذاته.
كما يوضح أن السردية السينمائية شهدت في تلك السنوات تحولاً لافتاً، إذ انتقلت من الخطاب الجماعي ذي الطابع الثوري المباشر إلى مقاربة أكثر فردانية، تنبش في الهويات المتشظية وتُعيد التفكير في معنى المقاومة، لا باعتبارها مجرد فعل عسكري، بل كتجربة شخصية ومكانية ونفسية في آن واحد.
ومن أبرز الأفلام التي عكست هذا التحول أعمال المخرج هاني أبو أسعد، وعلى رأسها فيلم "عمر" (2013)، الذي مثّل فلسطين في سباق جوائز الأوسكار.
يروي الفيلم قصة عامل المخبز الشاب عمر، الذي يغامر يومياً بتسلق جدار الفصل هرباً من رصاص الاحتلال، في سبيل لقاء حبيبته نادية التي تعيش على الطرف الآخر.
وبقدر ما يحكي الفيلم عن حب محاصر فإنه يعكس كذلك مأزق الفلسطيني الممزق بين قسوة الاحتلال وتعقيدات الاختبار الشخصي في بيئة مشبعة بالقهر والخوف.
الفيلم الآخر الذي عُرض في تلك الفترة هو "معطف كبير" للمخرج الفلسطيني نورس أبو صالح، الذي يرصد التحولات التي عاشتها فلسطين بين عامَي 1987 و2006، بمشاركة مجموعة من الممثلين الفلسطينيين والأردنيين.
يوثّق العمل محطات مفصلية في التاريخ الفلسطيني، أبرزها الانتفاضتان الأولى والثانية واتفاقية أوسلو، من خلال قصة شاب يقرر دخول عالم الإعلام والإنتاج السينمائي. وبين طموحاته المهنية وعلاقته العاطفية بفتاة يحول الاحتلال دون اكتمال قصتهما. يقدم الفيلم صورة مكثفة عن التداخل بين الحياة الشخصية والتاريخ الجمعي للشعب الفلسطيني.
سينما المقاومة في غزة
مع وصول حركة حماس إلى السلطة بالانتخابات التشريعية ثم ما تلاها من اقتتال داخلي وسيطرة للحركة على قطاع غزة عام 2007، وتصاعد المقاومة الفلسطينية المسلحة المنطلقة من القطاع، بدأت تجربة فنية بالتبلور في القطاع المحاصر.
ركزت الاعمال المنتجة في قطاع غزة والتي أشرفت عليها مؤسسات فنية تابعة أو مقربة من حركة حماس على سردية المقاومة والقيم التي تعززها، كما تناولت سير أبطالها.
وخلال هذه المرحلة أُنتج عام 2009 فيلم "عماد عقل"، الذي تناول سيرة الشهيد عماد عقل، أحد أبرز قادة كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
كان عقل المطلوب الأول لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي لسنوات طويلة في تسعينيات القرن الماضي، قبل أن يُغتال في نوفمبر/تشرين الثاني 1993 بعد مطاردة حثيثة.
العمل السينمائي حمل طابعاً توثيقياً درامياً، إذ كتب السيناريو الدكتور محمود الزهار، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، وأخرجه المخرج الفلسطيني ماجد جندية، فيما تكفلت شبكة الأقصى الإعلامية بإنتاجه.
ويُعَدّ هذا الفيلم من أوائل المحاولات الجادة لإنتاج عمل روائي طويل يوثّق شخصية قيادية في حركة حماس، جامعاً بين البعد التعبوي والسياسي وبين السرد الدرامي الذي يستهدف الجمهور الفلسطيني والعربي في آن واحد.
وعلى امتداد الفترة بين عامَي 2007 و2023، شهدت الساحة الإعلامية الفلسطينية إنتاج عدد من الأعمال الدرامية التليفزيونية، التي جرى عرض معظمها في شهر رمضان، حيث يحظى المشاهد الفلسطيني والعربي بمتابعة واسعة في هذا الموسم. ومن أبرز هذه الأعمال مسلسل "قبضة الأحرار" الذي عُرض في رمضان 2023، وركّز على تجسيد الصراع الأمني والاستخباري بين المقاومة الفلسطينية والأجهزة الأمنية الإسرائيلية.
المسلسل كان لافتاً بما تضمنه من مشاهد تحاكي عملية طوفان الأقصى، التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية عبر هجوم منسق على المواقع العسكرية الإسرائيلية الممتدة على طول حدود قطاع غزة. وقد أعطى العمل بُعداً درامياً لهذه العملية، موثقاً عبر المشهد التليفزيوني صورة عن التخطيط والتنفيذ والمواجهة، بما يجمع بين الرسالة التعبوية والبعد الفني.